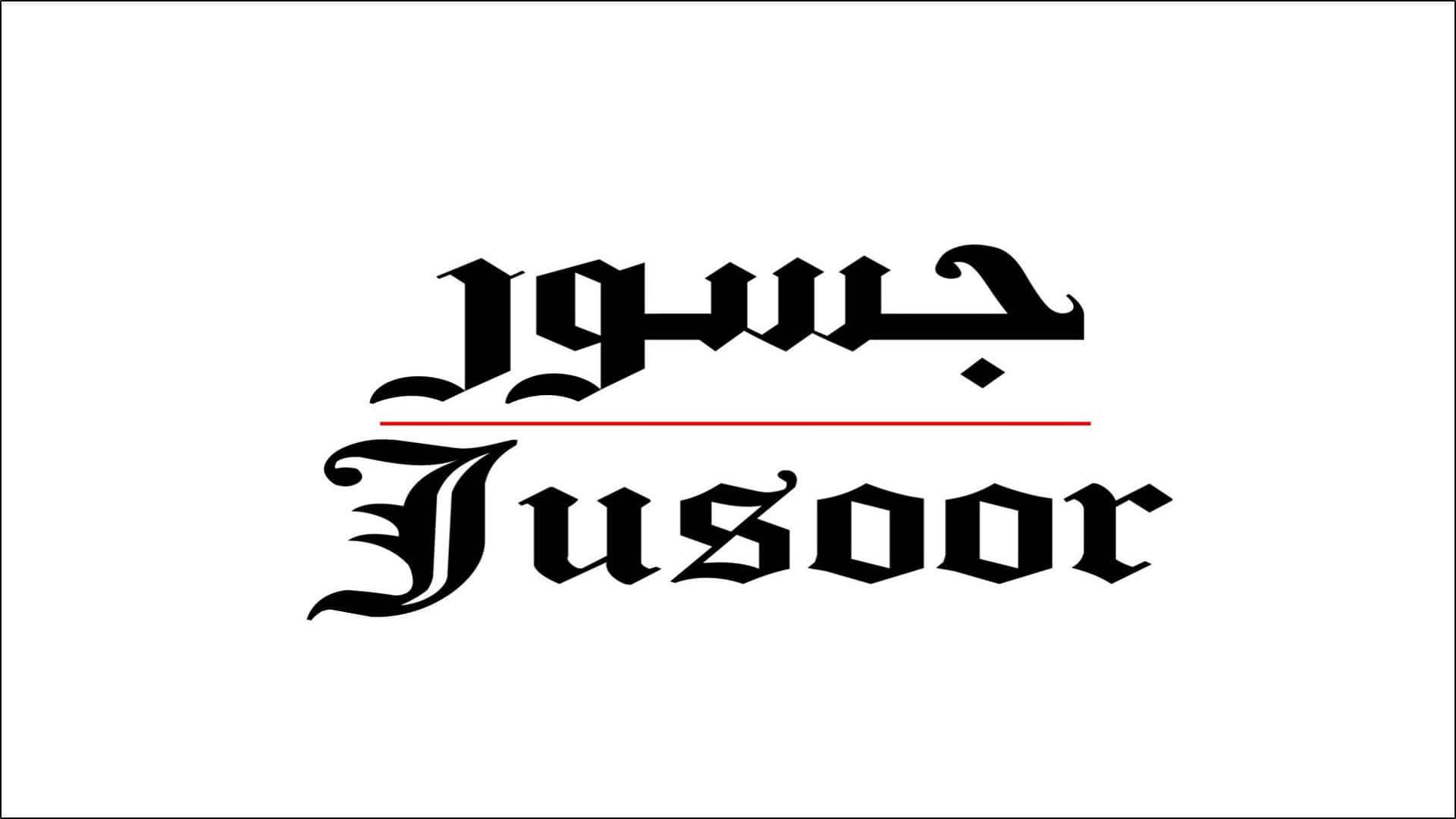جحيم العطش.. أزمة نقص المياه تزحف بشراسة في المدن الإيرانية
جحيم العطش.. أزمة نقص المياه تزحف بشراسة في المدن الإيرانية
في قلب جنوب غرب آسيا، حيث امتزجت الحضارات على ضفاف أنهار جرت منذ آلاف السنين، تحولت صورة الحياة من جداول رقراقة تسقي الحقول وتعانق المدن إلى صمت مياه يلف الأرض، يلتهم الندى ويبدد الأمل.
إيران، تلك الدولة التي لم تعرف يومًا عطشًا بهذا الحجم منذ عقود، أصبحت على حافة أزمة نقص مياه غير مسبوقة، تهدد وجودها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتنذر بمخاطر نزوح داخلي واسع، وتراجع الأمن الغذائي، وتفاقم الصراعات بين الأقاليم، في وقت لم يعد فيه الجفاف ظاهرة طبيعية عابرة، بل أزمة تكشف هشاشة السياسات المائية وتضع مستقبل البلاد أمام اختبار وجودي قاس.
ولا يعد ما يشهده الإيرانيون مجرد نقصان في المياه، بل انحداراً تاريخياً في مخزون الموارد الهيدرولوجية، فبعد ست سنوات من الجفاف المتواصل وجدت السدود الكبرى التي كانت في الماضي خزانات للحياة نفسها تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة، مع انخفاض حاد في التساقطات وموجات حرارة دفعت درجات الحرارة إلى ما فوق 50 درجة مئوية في الصيف.
في العام المائي الأخير، لم يتجاوز معدل الأمطار نحو 2.3 ملم، أي أقل بنحو 81% مقارنةً بالمتوسط التاريخي للفترة نفسها، وفق بيانات رسمية من منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، حيث يقف 19 سدًا كبيرًا على حافة الجفاف الكامل، وقد انخفضت مخزونات المياه في العديد منها إلى أقل من 5% من السعة الفعلية.
وفي طهران، التي يسكنها نحو 15 مليون شخص، خرج التحذير رسميًا بضرورة انتقال السكان خارج العاصمة إذا لم تسقط الأمطار، حيث أعلنت الحكومة إمكانية تقنين صارم للمياه في حال استمرار الجفاف، لا سيما أن المياه تُقطع في بعض المناطق لساعات يوميًا، نظرا لاستمرار موجة الجفاف الحالية.
وبينما يلقي البعض باللوم على تغير المناخ والجفاف الممتد، يشير الخبراء أيضًا إلى أن الإدارة المائية غير المستدامة والسياسات التي رُكزت على مشروعات ضخمة ببناء السدود ونقل المياه، دون تخطيط فعال، ما أدى إلى تعميق الأزمة، خاصة وأن المزارع الكبيرة تستهلك كميات هائلة من المياه، إلى جانب عدم جاهزية البنى التحتية، وعدم الاستثمار الكافي في تحديث أنظمة الري أو معالجة المياه، ما خلق فجوة بين الطلب والموارد.
وعلى وقع الأزمة، قد يضطر ملايين السكان في الأرياف والضواحي إلى النزوح الداخلي بحثًا عن مصادر حياة جديدة، لا سيما مع ندرة المياه، وانخفاض كمية المحاصيل الزراعية، ما يؤثر على الأسعار والغذاء المحلي، ويتجاوز مفهوم الأزمة المؤقتة، ليمتد إلى ندبةٍ عميقة في علاقة الإيرانيين بالمياه والموارد الطبيعية، حيث تقف البلاد عند مفترق طرق، إما إعادة هيكلة كاملة في طريقة إدارة الموارد، وإما مواجهة واقع أكثر قسوة.
السياسة تنتصر على المياه
في قرى جفت آبارها، ومدن باتت صنابيرها تعد القطرات، لا تبدو أزمة العطش في إيران مجرد أثر جانبي للتغير المناخي، بل حكاية طويلة من السياسات الخاطئة المتراكمة، هكذا يقرأ الباحث في الشأن الإيراني، إسلام المنسي، المشهد المائي الإيراني، مؤكدًا في حديثه لـ"جسور بوست" أن المناخ رغم قسوته ليس سوى عامل مُفاقم لأزمة أعمق صُنعت على مدى عقود في البلد الفارسي.
ويرى المنسي، أن جذور الأزمة تعود إلى إسناد المشاريع التنموية، لا سيما المائية منها، إلى جهات غير متخصصة، على رأسها مؤسسات تابعة للحرس الثوري وميليشيات عقائدية تملك نفوذًا واسعًا خارج الأطر الحكومية الرسمية، وبدل أن تُدار المياه بوصفها موردًا عامًا يخضع لحسابات علمية وتنموية، جرى التعامل معها بمنطق أيديولوجي، حيث لم يكن توزيعها محكومًا بالحاجة أو العدالة، بل بالولاء والهوية.
في جنوب غرب إيران، حيث تقطن غالبية عربية أحوازية، تحولت المياه إلى أداة تهميش، حيث تُحرم القرى من حصصها، وتُحول الأنهار بعيدًا عن أراضيها، لتصب في مناطق أخرى ذات أغلبية فارسية شيعية، غير أن المفارقة، بحسب المنسي، أن هذا الحرمان لم يُثمر تنمية حقيقية في المناطق التي نُقلت إليها المياه، بل ساهم في تبديد الثروة المائية للبلاد بأكملها، وكأن الجميع خسروا في نهاية المطاف.
ولم تقتصر تداعيات هذه السياسات على الأحواز وحدها، فمناطق الأقليات الأخرى، من الأكراد في الغرب والشمال الغربي إلى الآذريين، عانت بدورها من إهمال ممنهج وغياب استثمارات مائية عادلة، ما فاقم الشعور بالتهميش ودفع آلاف الأسر إلى الهجرة القسرية بحثًا عن حياة أقل قسوة، بحسب المنسي.
وهذا النزوح الداخلي، كما يوضح الباحث في الشؤون الإيرانية، أعاد رسم الخريطة السكانية للبلاد، حيث تكدست موجات جديدة من السكان في العاصمة طهران، مثقلة بخدمات لم تعد قادرة على الاحتمال، وفي الوقت ذاته، استمرت الدولة في التوسع بمشروعات زراعية ضخمة، دون وجود غطاء مائي مستدام، ما استنزف ما تبقى من الموارد، وعمق الفجوة بين الواقع والطموحات المعلنة.
ويخلص الباحث إلى أن أزمة المياه في إيران ليست أزمة طارئة ولا عابرة، بل أزمة بنيوية تعكس طبيعة النظام القائم على الازدواجية في القرار، حيث تتداخل صلاحيات الحكومة مع نفوذ أطراف موازية تمتلك سلطة أكبر من المسؤولين الرسميين أنفسهم، وفي ظل غياب خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تتراكم الأخطاء، وتتجسد اليوم في عطش يطارد المدن والقرى على حد سواء.
وبحسب تقدير المنسي، فإن حل هذه الأزمة يظل مستبعدًا ما دامت المعطيات التي أنتجتها لا تزال قائمة، لتبقى أزمة المياه جزءًا من سياق أوسع من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر إيران، وتضع مستقبلها أمام اختبار قاس، عنوانه الأبرز: "من يملك المياه يملك الحياة".
عطش من صنع البشر
من زاوية أخرى، تقرأ المحللة السياسية المتخصصة في الشأن الإيراني، منى سيلاوي، مشهد العطش في إيران بوصفه نتاجًا لإدارة أمنية قبل أن يكون أزمة موارد، وفي حديثها لـ"جسور بوست"، قالت إن المياه لم تُدر باعتبارها حقًا عامًا أو عنصرًا للحياة، بل كأداة لضبط مناطق الأقليات القومية والدينية، مقابل تركيز الخدمات والبنى التحتية في المناطق المركزية التي تشكل الحاضنة الأساسية للنظام.
وتوضح سيلاوي، أن ما تعانيه إيران اليوم هو "عطش من صنع البشر"، لا يمكن إرجاعه إلى الطبيعة وحدها، فقرابة 80% من الموارد المائية تُستهلك في قطاع الزراعة، غير أن هذه الزراعة لا تزال تعتمد أساليب تقليدية متهالكة، تُهدر كميات هائلة من المياه عبر التبخر وسوء الاستخدام، دون أي تحديث حقيقي يواكب شح الموارد.
ولا يتوقف الخلل عند الزراعة، بحسب سيلاوي، بل يمتد إلى التخطيط الصناعي نفسه، إذ جرى توطين صناعات كثيفة الاستهلاك للمياه في قلب المناطق المركزية ذات الطبيعة الصحراوية، في مفارقة صارخة مع أبسط قواعد التنمية المستدامة، ولتعويض هذا الخطأ، لجأ النظام إلى بناء السدود ونقل المياه من أقاليم أخرى إلى هذه المناطق، التي تقطنها الأغلبية الفارسية الشيعية، ما حول الأقاليم الطرفية إلى خزّانات تُستنزف لصالح المركز.
غير أن عملية نقل المياه لم تُنتج وفرة حقيقية، بل أدت إلى خسائر جسيمة، حيث تبخرت كميات كبيرة من المياه خلف السدود، وضاعت أخرى في الطريق، بينما حُرمت المناطق الأصلية، التي قامت حياتها تاريخيًا على الزراعة والمياه، من مواردها الطبيعية.
ووفق سيلاوي، فإن هذا النهج خلق طلبًا مصطنعًا وغير طبيعي على المياه في المناطق المركزية، في وقت يُقمع فيه أي صوت علمي معارض، إذ يُعتقل خبراء البيئة ويُزج بهم في السجون لمجرد اعتراضهم على سياسات نقل المياه بأدلة علمية.
ملف شديد التعقيد
وتصف سيلاوي ملف المياه في إيران بأنه "شديد التعقيد"، تتشابك فيه السياسة بالأمن، والاقتصاد بالأيديولوجيا، مقدمة كارثة بحيرة أرومية بوصفها نموذجًا فادحًا لهذه التداخلات، فبدافع تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، دفعت سياسات المرشد الأعلى علي خامنئي السلطات إلى تحويل مناطق غير زراعية إلى حقول إنتاج، وسحب المياه إليها، ما حرم البحيرة من مواردها الطبيعية.
ووفق ما رأته سيلاوي: "كانت النتيجة ارتفاعًا كارثيًا في نسبة الملوحة، شكلت عواصف ملحية لوّثت البيئة المحيطة، وقتلت النباتات، وحوّلت الأراضي الزراعية الخصبة إلى مساحات قاحلة غير صالحة للحياة، الأمر الذي دمر أنماط عيش السكان وأجبرهم على الرحيل".
وفي جنوب غرب البلاد، تبرز الأحواز كصورة أخرى لهذا الخراب الصامت، إذ تشير سيلاوي إلى أن مصادرة أراضي السكان واستبدال الزراعة التقليدية بزراعة صناعية لقصب السكر دمّر دورة اقتصادية متكاملة كانت تعيش منها نحو 700 عائلة، ومع دخول الصين بقوة إلى الاقتصاد الإيراني، وبيع السكر بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج المحلي، إضافة إلى تدخل أبناء المسؤولين والمتنفذين، انهار هذا القطاع بالكامل.
وبحسب الخبيرة في الشأن الإيراني، "لم يكتفِ هؤلاء بالقضاء على الزراعة التقليدية، بل دمروا أيضًا الزراعة الصناعية، بعد الاستيلاء على أراضي الأهالي، لتجد إيران نفسها مضطرة إلى استيراد السكر الصيني، وفي هذه الحلقة المعقدة، تداخل الفساد المالي مع الأمني، وتفاقمت الأعباء على الموارد المائية واستخداماتها، وصولًا إلى ما تعيشه البلاد اليوم من أزمة مياه وعطش صامت يزحف بلا ضجيج".
وتختم سيلاوي بالعودة إلى جوهر رسالتها للماجستير، التي تناولت استخدام المشاريع التنموية كأدوات للسياسات الأمنية بهدف التحكم في البشر، مشيرة إلى أن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا، فالطبيعة، كما تقول، هي التي فرضت كلمتها في النهاية، وانقلبت السياسات على أصحابها، لتدفع المجتمعات ثمن نوايا لم تكن يومًا خَيِّرة في تعاملها مع الأرض والمياه، ومع تراجع الموارد شهرًا بعد آخر، بات السكان وحدهم في مواجهة العطش والخراب.